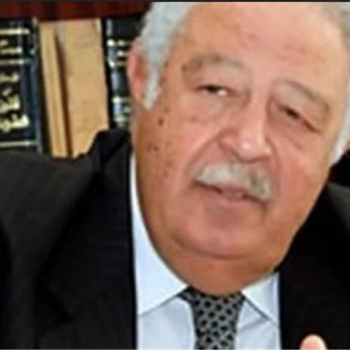عن أثر أوروبا الحديثة فى النهضة العربية الوطنية
حب الوطن غريزة فى الإنسان من أقدم عصوره الاجتماعية، عرفت فى البدو والرحل كما عرفت فى اصحاب الأرض الزراعية وفى سكان المدن، وبها تغنّى الشعراء والكتاب على مدار السنين.
غير أن الوطنية فى المصطلح الحديث التى يعنيها الأستاذ العقاد هنا- غير هذه الغريزة، وتنصرف اصطلاحًا إلى مجموعة الحقوق والواجبات، أو العلاقات والصلات الروحية والثقافية- وقد انفرد بها الإنسان الحديث بعد القرن الثامن عشر تقريبًا، واختلف فهم الناس لها عن ذلك الشعور الغريزى الذى تتفق مع الإنسان فيه الأحياء الأنيسة وبعض الضوارى.
لم يكن ميسورا نشوء الوطنية بهذا المعنى الاصطلاحى قبل القرن الثامن عشر، لأنه لم تكن قد استوت بعد الأطوار الإجتماعية التى مهدت لظهورها.
ولا شك أن نظام الاقطاع الذى حصر الانتماء فى «إقطاعات»- كان حائلا دون توالد الوطنية بمعناها الاصطلاحى الحديث، التى تربط الناس بقطر واحد يرتبطون به بضروب شتى من الولاء والمصالح المشتركة.
فكان لا بد إذن من تطور نظام الاقطاع، وكان لا بد أيضًا من تطور الجامعات الدينية التى يحول تعددها دون اتفاق الحاكم والمحكوم فى العقيدة وفى المراسم الروحية ويتعذر الحكم بحكومة واحدة، ونشوء الطبقات الإجتماعية التى تجمعها علاقة وثيقة واحدة.
ومع تطور نظام الإقطاع وعصر الجامعات الدينية، قام من بعدهما سلطان الملوك المطلقين الذين ساعدتهم قوتهم على قهر أمراء الاقطاع والاستئثار بسلطان العرش وحصر الولاء فى أشخاصهم أو فى أسرتهم.
وكانت هذه الممالك سابقة بطبيعة الحال للحقوق التى تنشأ من الاعتراف للأمة بالسيادة فى بلدها، وتهيىء للوطنية بهذا المصطلح الحديث، والتى بدأت مقدماتها مع بروز الطبقة الوسطى ودورها فى تقييد الملوك وزوال السادة الاقطاعيين.
ويرى الأستاذ العقاد أن الامة العربية كانت من أوائل الأمم التى نشأت فيها الوطنية بالمعنى الحديث قبل نشأتها فى أعقاب الثورة الفرنسية. لأنها كانت تدين بأن الأرض لله وأن الملك خادم للشعب قبل أن يرسخ هذا المفهوم فى أمم الحضارة الغربية.
على أن التاريخ لا يسبق أوانه، وكان لابد للجامعة الدينية من دور تجرى فيه وتبلغ مداه، وقد كانت هذه الجامعة فى أواجها بينما كانت الوطنية فى غيابها تنتظر الأسباب والمواقيت، فلما تهيأت الأسباب وحان الميقات، أفسحت للوطنية بمعناها الحديث، وإن كان من عجائب أطوار التاريخ أن أخذها الشرقيون عن الغربيين، تارة مكرهين وتارة مختارين.
وسبب التراوح بين الكره والاختيار، أن الشرقيين أخذوها بالتعليم والمحاكاة وأخذوها بكفاح الثورة على الاستعمار. فكانت المناداة بحقوق الإنسان فيما يقول الأستاذ العقاد- هى فاتحة الاعتراف بحقوق الاوطان. وكانت إغارات الأوروبيين على الأوطان الشرقية حافزًا لإشعال الغيرة الوطنية ومطالبة أبنائها بهذه الحقوق التى يمس كرامتهم وعقيدتهم مساس أو تعدى الاستعمار عليها.
وقد ظلت العاطفة الوطنية ممزوجة بالعاطفة الدينية فى شئون السياسة العامة ردْحًا من الزمن بعد الاعتراف بسيادة الأمة وقيام «فكرة الوطن». وقد كان شأن أوروبا فى ذلك كشأن الأمم الشرقية دون اختلاف كبير. ويمكنك ان تلحظ ذلك فى ثورة كل من ايطاليا واليونان فى طلب الاستقلال، فقد كان الانتصار الاوروبى لثورة اليونان اكبر برغم وحده أصول الحضارتين، والسبب أن اليونان كانت تثور على الترك، بينما كانت ايطاليا تثور على النمسا أو على الكنيسة البابوية.
وقد ظهرت نزعة الاستقلال عن دعوى الخلافة الدينية بين الشرقيين المسلمين فى اوائل القرن الثامن عشر، مقترنة بظهور هذه النزعة فى أوروبا، فكان السلطان العثمانى الملقب بلقب الخلافة يولى على مصر واليًا من قبله، ويختار المصريون واليًا غيره كما حدث على عهد محمد على الكبير.
وفى أواسط القرن التاسع عشر نادى طلاب الاستقلال بأن «مصر للمصريين» جعلوا هذا المبدأ شعارًا لهم فى حركة التحرير مع قيام السلطة العثمانية التى زالت بعد خمسين سنة.. ثم ظلت هذه السيادة تتردد فى بيئات الاحزاب السياسية، إما بفعل الشعور الدينى أو للرغبة فى مقاومة الاحتلال البريطانى بحجة شرعية لا يستطيع إنكارها.
وعلى ذلك لم يكن هذا الامتزاج بين العاطفتين الوطنية والدينية غريبًا فى عالم الواقع أو التفكير، ذلك ان العواطف الجديدة لا تولد دفعة واحده فى تطور الأمم.
ولذلك ربما كان الاصح، فيما يقول الأستاذ العقاد، أن يقال إن معنى الوطنية الحديث كان وليد الحضارة العصرية لا وليد الذهن الاوروبى أو الطبائع الغربية.
الحركات الدينية
تعلم الشرقيون من أوروبا ليقاوموها بسلاحها.
بهذا يبدأ الأستاذ العقاد هذا الفصل، منوهًا بأن هذا يقال عن الشرق الأقصى كما يقال عن الشرق الأدنى، مع اختلاف العقائد والبيئات والأحوال الإجتماعية.
فاليابانيون لم يتحركوا لمحاكاة أوروربا فى حضارتها وعلومها وصناعاتها، إلإَّ بعد أن اصطدموا بها وعجزوا عن مقاومتها.
فإذا كان لأوروبا فضل، فقد جاء للشرق على الرغم منها، بتنبيه أذهان الشرقيين إلى حقائق الحياة وإلى الأسباب الصحيحة لنهضات الشعوب.
قبل ذلك كان الشرقيون يعلمون بتأخرهم وتخلفهم، ولكنهم فهموا علة ذلك كفهم المريض الذى يبحث عن علة مرضه وعجزه عن طريق الشعوذة، ولا يرجع إلى الطب الصحيح.
وقد التبس جهل الدين بجهل الدنيا، للخلط بين العادات والعقائد وبين خرافات الجمود وحقائق العبادات. فلما غلبت أوروبا فى عدوانها على الشرق مرة بعد مرة، تنبه الشرقيون مضطرين إلى أسباب هذه الغلبة فرجعوا بعد حين إلى علومها وصناعاتها ونظم السياسة والحكم فيها، واستوت لهم الأمور بعد أن فهموا علل الوقائع الماثلة على وجهها المعقول.
وكادت تتفق الأراء على منهج واحد للإصلاح: وهو اقتباس العلم الحديث، ومجاراة العصر فى التفكير والمعيشة.
وأقبل المسيحيون من أبناء الشرق على المدارس العصرية يتعلمون فيها دروس التعليم الحديث غير متحرجين، بينما أحجم المسلمون لأن هذه المدارس كانت فى أيدى المبشرين وأعوان التبشير.. ولكنهم لم يحجموا عن إرسال أبنائهم لتلقى العلم فى أوروبا التى تنفصل فيها المدارس أو الجامعات عن الهيئات الدينية. وقد أرسلت مصر فى عهد محمد على الكبير مئات من نخبة الطلبة لتلقى الطب والهندسة والأداب والفنون العسكرية على أساتذتها فى العواصم الأوروبية.
ولم يمض جيل أو جيلان فيما يقول الأستاذ العقاد حتى اتفقت كلمة المسلمين على نظرة جديدة للدين، وأجمعوا على نبذ البدع والخرافات التى شقى بها أسلافهم وشقوا بها فى زمانهم، وليست من الدين الإسلامى فى شىء.
ولكنهم سلكوا فى العلاج مسلكين تبعًا لنصيبهم من العلوم العصرية : جنحت أمم إلى التوفيق بين الدين والعلم الحديث، وجنحت أمم أخرى إلى نبذ جميع المستحدثات والرجوع بالدين إلى بساطته الأولى كما فهموها.
ونشأت هنا وهناك حركات دينية، تبعًا لطـبائع الأمم وبواعث الـبـيئة فى حاضرها وماضيها.
ولهذا أخذت هذه الحركات الدينية، من طبائع الأمم التى ظهرت فيها، سواء منها ما اهتدى أو ضل عن السواء.
فظهر فى الهند «غلام أحمد القاديانى» الذى زعم أنه هو عيسى بن مريم وانه هو المهدى وهو الإمام المنتظر فى مذهب الشيعيين يوفق بين الإسلام والمسيحية وبين الشيعيين والسنيين، إلى آخر ما ظهر فى الهند تبعًا لهذه العقيدة. ومن اليسير جدًا معرفة ما فى هذه الحركة من بقايا البيئة الهندية.
وظهر فى إيران «ميرزا على محمد الشبرازى» الذى زعم أنه الإمام المنتظر ثم انتحل عقيدة الإسماعيلية وبث فيها عقيدة وحدة الوجود، ثم وثب إلى القول ببطلان الشريعه الظاهرة والأخذ بالحقيقة الباطنه التى تبيح الحلول وتوابعه. ومن اليسير جدا أيضًا أن تلمس فى هذه الحركة نزعة البيئة التى نشأتها فيها طلائع الباطنية والإسماعيلية أو نزعة الحلول.
وظهرت فى الجزيرة العربية دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب التى انكرت الترف فى الكساء والبناء، وابطلت معانى الرموز والاشارات والتوسل بالأشياء إلى آخر ما مر بنا سلفًا فى تناول كتاب : «الإسلام فى القرن العشيرين»- ومن اليسير جدًا أن نلمس هنا أيضًا أثر فطرة الصحراء فى هذه الصرامه وهذا الفصل الحاسم بين عالم الحس وعالم الغيب.
ويصدق ذلك ايضًا على الدعوه المهدية التى ظهرت فى السودان، ويتضح فيها أثر ثورة السودانى على مستقليه.
وظهرت فى مصر دعوة الإصلاح التى وجدت إمامها الأكبر فى الشيخ محمد عبده، فكانت تعليمًا جديدًا فى مدرسة قديمة، وكانت تفسيرًا للقوانين الإلهية لا يخرج بها عن نصوصها ولكنه يحفظها فيها ويقتبس منها المعنى الذى يوافق معارف العصر الحديث.
ومن اليسير جدًا أن تلمس هنا أيضًا روح العصر فى مصر التى عرفت نظام الحكم منذ ألوف السنين، والتى عرفت التوحيد من الآف السنين.
وقد صمد الإسلام للرجَّة الأولى، وانتظمت المصالحه بينه وبين الحضارة العلمية، ولم تعد بينه وبين العلم الحديث مشكلة، وإنما المشكلة اليوم أن يؤدى رسالته ورسالة الأديان عامة فى مكافحة اللوثة المادية التى تريد أن تلغى مطامح الروح وتود لو جعلت الإنسان حيوانًا بغير دين غير دين المعدات والاجسام !
Email: [email protected]
www.ragai2009.com