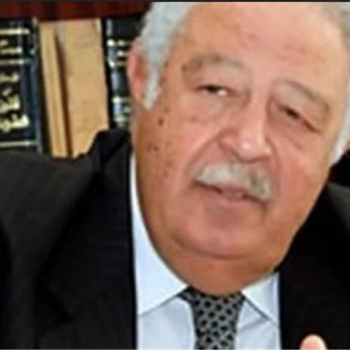دور من أدوار التاريخ
فى الكتابة عن الأندلس الإسلامية
أعجب من زوال دولة الإسلام فى الأندلس، فيما يقول الأستاذ العقاد فى هذا المقال المنشور فى مارس 1959 بمجلة الأزهر أن آثارها لا تزال باقية حتى اليوم، فى كل ناحية من نواحى الحضارة الأوروبية.
ويكفى أن نذكر من آثارها الباقية- قيام دعوة الإنسانية منذ القرن الثانى عشر للميلاد، ثم قيام دعوة الإصلاح وما يليها من الثورات الاجتماعية والسياسية- لنعلم أن آثار الإسلام فى الأندلس قد أحاطت بأصول كل حركة من حركات الثقافة الغربية الحديثة.
إلاّ أن مواقف المؤرخين والباحثين الأوروبيين من تقدير هذه الآثار مواقف مختلفة، وأحيانًا متناقضة، تترواح بين الإنكار والاعتراف، وبين التهوين والإكبار.
فى عصر «التعصب الدينى» من بقايا القرون الوسطى، كان الغالب هو خطة «الإخفاء والطمس» للعلوم والآداب الإسلامية.
وبعد القرون الوسطى، وفى عصر الكشف والتنقيب عن المجهولات فى كل باب من أبواب المعرفة الإنسانية، انكشفت مفاخر الحضارة الإسلامية فى الشرق والغرب، وكان للحضارة الأندلسية نصيبها الأوفر من العناية وإن تفاوتت مواقف المؤرخين والنقاد الغربيين منها.
فمنهم من كان ينظر لموضوعه من خلال نزاع الكنيسة والمنشقين عليها فينحاز لمن اضطهدتهم الكنيسة وحرمتهم.
ومنهم من كان ينظر للموضوع التاريخى من خلال النزاع على السلطة القائمة فيتخذ من المواقف ما يناسب هواه.
ومنهم من كان يعمل لحساب الاستعمار السياسى فينكر فضائل الإسلام، أو يقف فى شهادته له عند حدود الماضى ولا يتعداها إلى الحاضر الذى غلبت فيه السيادة للمستعمرين.
ومنذ الحرب العالمية الثانية تغيرت هذه المواقف جميعًا وخلفتها مواقف أخرى أقرب إلى الإنصاف والاستقلال النظرى.
والذين يكتبون اليوم عن الأندلس الإسلامية يجمعون بين النزعة العالمية ونزعة «الهوية الشخصية»، دون أن ينسوا مطالب النشر التى تتحرى ميول القراء ولا تخضع للإملاء من جانب الدول أو الهيئات.
ومن أحدث المؤلفات التى ظهرت فى هذا الدور، يشير الأستاذ العقاد إلى كتاب «الأندلس» أو أسبانيا فى ظل المسلمين، وصدر سنة 1958، لمؤلفه الأستاذ «ادوين هول Edwin hole» المستشرق المعروف.
وقد عمل هذا المؤلف بمصر وسوريا وتركيا والبلقان، واغتنم فرصة العمل فى وكالة «مالقة» القنصلية، فعكف خمس سنوات على دراسة الحضارة الأندلسية من قريب، ووضع هذا الكتاب الموجز الذى يقع فى نحو مائتى صفحة ويشتمل على أحدث الأقوال والآراء فى تاريخ هذه الحضارة، وجملة ما يقال عن كتابه، إنه أنصف حضارة الأندلس الإسلامية فيما فهمه وتأتى له أن يحكم عليه، وإن كان قد جهل منها بعض جوانبها، وسيما جانب الشعر والأدب، فأحال التبعة فيه على غيره ممن يحسنون ذلك.
ويورد الكتاب أن المعجزة التى صنعتها الدولة الإسلامية فى القارة الأوروبية، تبين فى مكتبة الخليفة «الحكم» التى ضمت كتبها ومجاميعها نحو أربعمائة ألف كتاب ومجموعة، وقد حاول الملك الفرنسى شارل الملقب بالحكيم، حاول بعد أربعة قرون من «الحكم» أن ينشئ مكتبة تضارعها فلم يستطع أن يجمع فيها أكثر من تسعمائة كتاب، منها ستمائة تبحث فى اللاهوت.
وقد تجاوبت آفاق القارة الأوروبية بسمعة الخلفاء المسلمين فى طلب العلم والتحصيل والحرص على إقامة المكتبات واقتناء الكتب النفيسة والمدونات النادرة، فكان «الكتاب» أعز الهدايا التى يخطب بها ود الخليفة بين ملوك القارة وأمرائها، وكانت السفارة الناجحة فى بلاط قرطبة هى سفارة الملك الذى يزود رسوله بتحفة من تحف العلم والحكمة.
ويقول المؤلف «إدوين هول» فى سياق كلامه عن الكتب : «إن الرغبة فى المعرفة كانت مستفيضة لا حدود لها. وقد حدث أن الإمبراطور البيزنطى أرسل إلى «عبد الرحمن الثالث» كتاب : «ديو سفريدس» فى العقاقير، فعهد إلى جامعة الطب بترجمته وحل رموزه، وكان «الحكم بن عبد الرحمن» نفسه من كبار العلماء يشترك فى البحث ويبعث بالوفود إلى أطراف البلاد لشراء المخطوطات ودعوة العلماء إلى بلاطه حيث يعاملون معاملة السخاء والحفاوة، فأصبحت أسبانيا قطبًا قويًّا يجذب أساطين العلم من كل مكان».
وقد أفاض الكتاب فيما يشير الأستاذ العقاد- فى استقصاء أخبار المكتبة الأندلسية من مصادرها، ويذكر له أنه لم يقتصر على بيان أن المدرسة الأندلسية مدرسة معقولات ومحفوظات، قصاراها أن تحشو الأذهان، بل حرص إلى جوار ما يردده الأوروبيون عن «ديدان الأوراق» على بيان أن الإطلاع على نوادر هذه الكتب كان زادًا من أزواد المعيشة الصالحة والحياة الإنسانية.. حياة الحس والعاطفة وحياة السلوك المهذب والكياسة العملية وما توحيه آداب المعاشرة الطيبة فى البيئة الإسلامية وما تحتك به من البيئات الأوروبية، والتى ينقل الأستاذ عن الكتاب طرائف شيقة منها.
● ● ●
كانت هذه الحضارة حضارة متاع ونعمة، وحضارة عقل وفهم وعاطفة.
كانت حضارة إنسانية كاملة.
أما الذى فات المؤلف أن ينصفه فى تلك الحضارة، فهو ما فاته إدراكه من بلاغتها الشعرية الشائقة : بلاغة الموشحات والألحان.
وقد ساق الأستاذ العقاد من أسباب ذلك ما كان حريًّا أن يجعله أكثر تسامحًا فى هذه الجزئية، فقد ذكر أنه لا ينتظر ممن لا يحسنون الحكم على شاعر من أبناء جلدتهم ولغتهم، أن يحسنوا الحكم على الشعراء من أبناء اللغات التى تخالف لغاتهم فى تراكيبها ومصطلحاتها.
لذلك يعذر الأستاذ العقاد من يجهل ولا يدعى أنه يعلم، وإنما اللوم على من يسىء النية قبل أن يسىء الفهم، ويحسب للمؤلف أنه صحت نيته وصح إنصافه وإطراؤه للحضارة الأندلسية الإسلامية فيما يفهمه وتأتَّى له الحكم عليه.
Email: [email protected]
www.ragai2009.com