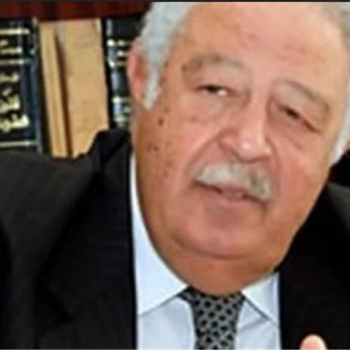الأصل والنقل
يتصدى الأستاذ العقاد فى هذا الفصل، للبدعة العصبية التى تنسب إلى الحضارة العربية أنها كانت قاصرة على النقل دون الإبداع الذى يتميز به العنصر الأوروبى، والزعم بأن هذه السمة سمة النقل لازمت الجنس العربى منذ أقدم العصور، فسبقهم السمريون الذين بلغوا شأوًا عظيمًا من الحضارة والعمران تدل عليه آثارهم، ومن ثم كان البابليون والكلدانيون مسبوقين- لا سابقين- إلى حضارتهم بين النهرين.
وأنه لما تجدد ظهور العرب بعد الإسلام وصارت لهم حضارة، فإنها بدورها كانت حضارة منقولة لا مبدعة. وأن سمة النقل ثابتة من أن كل من نهضوا بأمانة الثقافة فى ظل الدولة العربية، كانوا إلاّ القليلون من الشعوب الأعجمية التى دانت بالإسلام، لم يكونوا من العرب الأصلاء.
ويبدأ الأستاذ العقاد تصديه لهذه العصبية، بأنه لا توجد حضارة أبدعت ولم تنقل، كما لا توجد حضارة جميع علمائها من عنصر محض خالص ينتمون إليه ولا يمتزج بالعناصر الأخرى.
فالإغريق نقلوا قبل أن يبدعوا، ونبغ علماؤهم فى آسيا الصغرى وجزر الأرخبيل وصقلية والإسكندرية وفلسطين والشام وتخوم العراق، ولم ينحصر نبوغهـم فى مكان واحد.
ويصدق هذا على الهند وفارس والصين، كما يصدق على أية أمة من سلالات الأوروبيين.
والقول بأن العرب لم يبدعوا شيئًا غير ما أبدعه السمريون هو محض تخميـن وتظنين، ولا موضع للجزم بأن العرب نقلوا ولم يبدعوا، وأن السمريين قبلهم أبدعوا ولم ينقلوا.
واشتراك الأمم الأعجمية غير المنكور فى حمل أمانة الثقافة فى العهد الإسلامى، ينبغى أن يلاحظ فيه أن هذه الأمم لم تنهض هذه النهضة إلاَّ بعد ظهور الإسلام فيها، ولم يكن لها شىء من ذلك إبان مجدها القديم.
والزعم بوجود عجز أصيل فى تفكير العربى وقلة استعداده للبحث الفلسفى والاهتمام بالمدرسة النظرية والاهتمام بالمعرفة والاستطلاع هو زعم بلا حجة، بل وتكذبـه الشواهد. فالذين جمعوا الحديث فى أول حركة الجمع كانوا كالبخارى وغيره من الأعاجم، وكان أقلهم من العرب الأصلاء. ولم يقل قائل إن العربى تعوزه ملكة الرواية وحفظ الأنساب والأسناد!
وذلك يوجب إذن الرجوع إلى سبب غير السبب العنصرى المزعوم لتعليل القلة الملحوظة فى عدد العلماء من العرب الأصلاء فى بعض العصور.
إن الثابت المعروف أن العرب الأصلاء اشتغلوا بالفلسفة والحكمة فى الأندلس، وأن تاريخ الثقافة العربية يشتمل على نوابغ عربية كابن الهيثم والحسـن بن أحمـد والهمدانى (المتوفى سنة 334 هـ) صاحب كتاب «سرائر الحكمة وأنساب حِمْير»- وهو محيط بمباحث الفلسفة عن أصل العالم وقواعد المنطق والكلام، ومثل ابن النضر القاضى المتبحر فى معرفة الأسباب والعلل. وفى كتب التراجم والسير ولا سيما أخبار الحكماء للقفطى خلاصة طيبة عن كثير من الفلاسفة والحكماء ممن لم يرزقوا الشهرة فى صدر الإسلام، وقد اشتهر مع هذا رجال كالكندى والفزازى وأبناء موسى بن شاكر الثلاثة.
وهناك من الأسباب الظاهرة لاهتمام الأعاجم ما لا يرتد إلى النقيصة المزعومة فى حق العرب الأصلاء، وإنما إلى ظروف وحوافز دعت إليه، بعضها راجع إلى الحضارة العربية ذاتها التى احتضنتهم ووفرت ما يعين على البحث والنظر. ومن أسباب اهتمام الأعاجم أنهم كانوا قد سبقوا إلى صناعة الكتابة، بينما كان العرب فى صدر الإسلام أصحاب قيادة ورئاسة وشغلتهم الفتوح. ومن هذه الأسباب أن الأمم الطارئة على الإسلام كانت أحوج إلى تعلم اللغة والفقه والبحث عن مصادرهما، ومنها أن الدولة العباسية قامت على الأعاجم وقربتهم وتعهدتهم بالمكافأة والتشجيع فأقبلوا على البحث والعلم. ومنها أن عدد الفضلاء الأعاجم هو عددهم بالقياس إلى جميع أفراد الأمم التى ينتمون إليها، أما عدد الفضلاء من صميم العرب فهو عددهم بالقياس إلى الفاتحين الراحلين عن الجزيرة العربية. ومنها أن الجدل والمناظرة من لذات الأمم المغلوبة لأنها تلتمس فيها الغلب الذى فاتها.
فلا محل لافتراض القصور العنصرى.
والثابت أن «الدفعة» التى أحيت الحضارة فى الدولة الإسلامية قد جاءت من السلالة العربية، وأن «حضانة» الدولة الإسلامية هى التى وفرت الظـروف لهـذه الدفعة، وسمحت أيضا ببقاء ما بقى من حضارات الفراعنة والإغريق والفرس والهند، ولولا وجود قوة «موجبة» فى العبقرية العربية لما جاءت تلك «الدفعة» ولا تيسرت تلك «الحضانة».
أجل ليس كل ما انتقل على أيدى الحضارة الإسلامية كان عربيًّا محضًا فى الأصول والفروع، ولكن حسب الحضارة الإسلامية أنه قد اتصلت بفضل وشائجها بالتاريخ القديم والحديث، وحفظت تراث الإنسانية كلها وزادت عليه ونقلته بما زادته إلى من تلاها.
الطب والعلوم
أشاد هوميروس فى الأوديسا- بمهارة الأطباء المصريين، وقال هيرودوت غير مرة إنهم كانوا يعالجون أنواعًا شتى من الأمراض يختص كل منهم بمرض يبرع فى علاجه- وروى أن «قورش» أرسل إلى مصر فى طلب طبيب للعيون، وأن «دارا» كان عظيم الإعجاب والثناء عليهم، وكان الإغرايق يعرفون اسم «امحوتب» رب الحكمة فى مصر القديمة، وقد نقلوا عن الطب المصرى كثيرًا من العقاقير كما نقلوا آلات الجراحة.
وتلقى الإغريق شيئًا من الطب الكلدانى كما كان فى عصوره القديمة.
ثم دارت دورة الثقافة الإنسانية، فأعاد الإغريق ما أخذوه وزادوه إلى المصريين فى عهد مدرسة الإسكندرية، إلى الكلدانيين والسريان فى أواخر الدولة الرومانية الشرقية، وكان ذلك الحين حصة من تراث الأديرة وكهانها.
واستعان الفرس بأطباء السريان والروم، فأنشأوا المدرسة الطبية والمستشفى المشهور بجنديسايور.
وقد عرف العرب التطبيب فى أقدم عصور الجاهلية على طريقة البداوة فى مزج الطب والكهانة وعلاج الأمراض بالوسائل البدائية.
وكان طب العرافين لديهم يخلط بين الرّقى والتبخير وتعاطى الأدوية التى تقترن بالعزائم والتمائم والتعاويذ، وكان هناك مختصون بالعلاج لا يزاولون الكهانة، ويعالجون بالفصد والكى والحجامة والحمية وبعض العقاقير والأعشاب التى تنبت فى بلاد العرب أو تُجلب من الهند والصين.
وجاء الإسلام فقضى على الكهانة وفتح الباب على مصراعيه للطب الطبيعى، وكان النبى عليه السلام يسمح باستشارة الأطباء ولو من غير المسلمين كما فى مرض سعد بن أبى وقاص الذى طلب إلى «الحارث بن كلدة» وكان على غير الإسلام، أن يعالجه.
وكثر اشتغال المسيحيين بالطب فى ظل الدول الإسلامية، ونبغ الأطباء بين نصارى المشرق.
(يتبع )